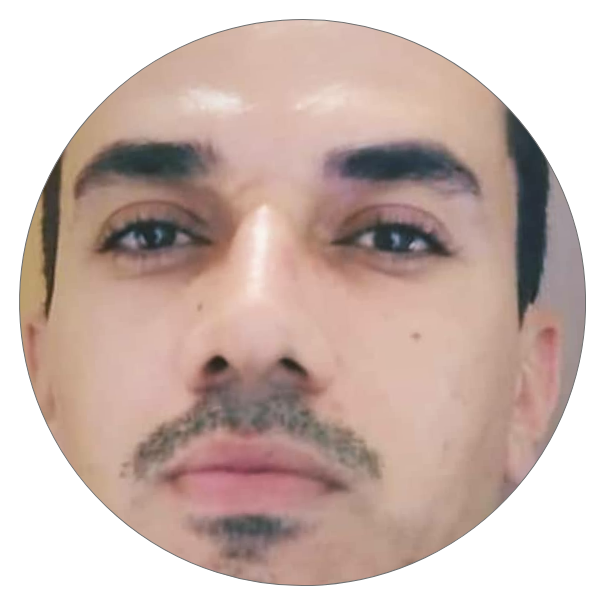كانت سيّارة الأجرة تتأرجح على طريق ترابية كما فعلت بي دائما دفّة الأحداث. ربّما كنت أبحث عن شيء ما داخل هذه العتمة. امتلكني شعور غريب هو مزيج من الخوف والفرح ثمّ الرهبة من المجهول. مزيج لم أشعر به من قبل.
لم ينته هذا الشعور المريب حتى توقّفت السيارة. نزلنا منها. وقف صديقي أو مضيّفي الجديد واسمُه سعيد أمام بيته. بيت تحيطه أشجار الموز والمانجا من كل جانب. وقف سعيد يتحسّس مفاتيحه. كان الباب لا يتجاوز المتر والنصف، دُفن أغلبه تحت التراب المتراكم أمامه كأنه إحدى المنازل المهجورة في قصص الرعب. كان في الباب خمسة أو ستّة أقفال. جعل سعيد يديرها ببراعة وسرعة عجيبتين حتى ارتبتُ في أمره. عاد ذاك الشعور الغريب مجدّدا. أيكون وراء الباب كنز يقتضي كلّ هذه الأقفال؟ أم إنّه يخفي سجنا أو إحدى دور التعذيب والاتّجار بالبشر؟
كانت الأسئلة تنهال عليّ والسيناريوهات المرعبة لا تنفكّ تتزاحم في مخيّلتي. لم أنتبه من حيرتي إلاّ على صوت سعيد يسألني عن الساعة؟! أقسم أنّي هممت أن أجيبه: ما المسؤول عنها بأعلم من السّائل؟! تبّا، أتراني مازلت قادرا على السخرية وسط هذا الرعب؟
نعم، أنا أيضا كنت بحاجة إلى معرفة الوقت. أن أعرف هل مازالت تجري عليّ مواقيت الدنيا أم أنني سافرت إلى زمن غابر عبر آلة الزمن. أحسست أنّني عدت بالزمن إلى بداية الخمسينات. جعلني ذلك أفقد اهتمامي بالوقت. أجبت سعيد متلعثما: “الساعة الآن الثانية صباحا” كان ذلك الوقت الذي أخبرني به هاتفي غير الذكيّ، أمّا في الحقيقة فلم تكن الساعة تتجاوز الواحدة صباحا. هاتف ضخم مليء بالأزرار، لا يحتوي تطبيقا للخرائط ولا يدلّني إلاّ على توقيت بلدي الذي غادرته. فهو لا يمتلك خاصيّة التحيين الأتوماتيكي ولا يوجد به أنترنت.
أمّا مكاني، فأنا الآن في مكان ما من أرض الله الواسعة، ما وراء الصحراء، غرب القارة السمراء. لقد أصبحت تماما على خطّ غرينتش، ولم تعد تضرّني الخطوط ولا مواقيتها ما دمت قادرا أن أتحسّس قلبي وتوقيته.
لا أعرف حقيقة أين أنا أو في أيّ حيّ. المهمّ أن قلبي وجد موطنا يلجأ إليه ليبني فيه ما تبقى من أحلام وميقاتا جديدا.
أتمّ الرجل فتح بابه العجيب ودعاني إلى الدخول وأنا أجرّ حقائبي التي لم تكن أثقل من همّي. هل نجوت فعلا؟!
دخلنا وألقينا تحية أهل البيت. كنت أعتقد من هول ما رأيت أنّ هذه الدار مهجورة، وأنّ ليس لهذا الباب ما بعده. رواق طويل لا تكاد ظلمته تنتهي حتى يتراءى لك ضوء خافت من غرفة في آخره. على الجانب الأيمن من الرواق كان المطبخ الصغير الذي لا يوجد داخله إلا ثلّاجة تداعى بابها وتآكل. لمحت صراصير تحوم حولها تبحث عن شيء تقتاته. صرتُ أكره الصّراصير من يومها لأنّني كنت جائعا جدّا واستحيت أن أقتحم عليها سهرتها فتقوم بمهاجمتي، ولم يتبقّ لي جهد أدفع به صرصورا واحدا.
رفعت بصري إلى السقف الذي تهاوى أغلبه حتّى برز حديده المتدلّي. على الجانب الأيسر كان المرحاض التركيّ بلا باب، تنبعث منه روائح كريهة تأخذك في رحلة مجانية إلى مراكز الإيقاف في الدول العربية.. وسط هذا كلّه، كانت الرطوبة عالية جدّا وحرارة جسمي ترتفع. إنّه موسم الأمطار في البلدان الاستوائية. بدأت أتعرّق. يجب أن يكون في هذا البيت اللّعين حمّام. يجب أن أسكب على جسدي الماء فقد كان كلّ شيء يخنقني، خصوصا تلك الأسئلة التي أردت أن أنتزعها وأخلي ذهني منها وأتوضأ. لا بدّ أنّ وضوئي انتقض خلال الرحلة.
دخلتُ الغرفة اليتيمة. كان سعيد يتقدّمني ببضع خطوات ليطرد بعض الفئران والجرذان التي احتلّت فراشه. لم أنتبه إلاّ وأحد الجرذان يمشي فوق قدمي…
كانت الغرفة مليئة بالجرائد والكتب القديمة المرمية على الأرض أو المبعثرة فوق الرفوف. اكتشفت فيما بعد أنها لعمّ صديقي الذي اشتغل صحفيّا لسنوات طويلة. في الزاوية شيء ما يشبه مروحة الهواء إلا أنّه لا ساق لها ولا تاج يحيطها. كانت تدور في شكل سرياليّ كأنّها تنهي مشهدا في فيلم الجرائم الهوليودية.

“كنت أعتقد من هول ما رأيت أن هذه الدار مهجورة وأن ليس لهذا الباب ما بعده”. عثمان سالمي، إنسان
اقتربت من السرير. كان عليه فرشة قديمة كُتب على إحدى زواياها 1958 وشارة الأمم المتحدة. أووف، الأمم المتحدة اللعينة من جديد تتبعني حتى في إحدى البقاع المنسية. كان سُمك الفرشة في الحقيقة لا يتجاوز الخمسة سنتيمترات لكنّ اختلاطها بالوسخ والكتب والجرائد جعلها أكثر متانة وسُمكا. فكّرت أنها ربّما فرشة من بقايا نصر الحلفاء على الألمان وقد وزّعوها على المرتزقة وفقراء إفريقيا.
لم أكفّ عن التفكير في التاريخ وأنا أدير بصري في الغرفة باحثا عن نافذة أو باب آخر أو مهرب. كانت النافذة مقفلة بشبكة من الحديد اختلط بالتراب والمطر فلم يعد الهواء يدخل عبرها.
خرجت من الغرفة تاركا حقائبي أرضا باحثا عن منفذ آخر. كان هناك باب صغير لم أنتبه له فطلبت من سعيد أن يفتحه. وجدتني أمام حديقة منزلية صغيرة مليئة بالأعشاب الطفيليّة والحراشف الاستوائيّة أظن أن لا أحد دخلها منذ عشر سنوات ولكن فكرة النوم هنا في البريّة الصغيرة أرحم بألف مرة من تقاسم السرير والغرفة مع “صديقي” …
أردت أن أستحمّ. كانت تلك الرغبة تقتلني. لم أعد أستطيع التنفّس وسط هذا الزخم الكبير من الأسئلة والخوف والرطوبة المرتفعة. طلبت من سعيد أن يمدّني بإبريق ماء. اتّجهت مسرعا إلى إحدى زوايا الرواق أين نزعت ملابسي وسكبت على جسدي الماء البارد. أقسم أنني أردت أن أنزع كل عضو في جسدي حتى أفركه وأدلكه بالماء. كل ذرّة من جسدي كانت تستحق الغسل على حدة…
أنهيت غسلي. كان هو قد جهّز الفرشة ونفضها من الاتربة. أتاني بسكّين قلّمت به بعض الأعشاب التي كانت تحيط بالحديقة، ثم بسط الفرش على الأرض. تسلّلت أنا باحثا عن سجّادي في ذلك الزحام.
أين القِبلة؟! لم أحر جوابا…
لم أضع القِبلة يوما فقد كان قَلبي دائما قِبلتي. ثم إنه لا قبلة للإنسان إلا قلبه، فأنّما ولّاه فثمّة وجه الله (هذا بقية من حديث قديم في قطار العودة). لم أنتبه أنني وضعت السجّادة في الاتجاه الخاطئ إلاّ حين نبّهني صديقي إلى الاتجاه الصحيح مبتسما.
كانت هناك فكرة واحدة تجول في خاطري. يجب أن أصلّي. أن أدعو الله حتى ينجيني من هذا الجحيم. لكن هل أنا حينها قد صليّت حقا؟ لم تكن صلاة تقليدية أو عادية. كانت إحدى أطول صلوات حياتي. هل قرأت فاتحة الكتاب؟ أيّ سورة قرأت؟ وكم ركعة ركعت؟ لا أذكر… لكنني أعرف أني قد سجدت طويلا حتى انقطع نفسي وأنا أردّد “اللهمّ إنك تعلم وأنا لا أعلم… اللهمّ إنك تعلم وأنا لا أعلم …”
أذان الفجر… لم أنم ليلتها إلاّ وقد انفطر قلبي وظننت أني نُسيت في إحدى غابات إفريقيا. أنا القادم من أوروبا وقد عشت بعض النعيم هناك. ظننت أني الآن التائه الوحيد في صحراء إفريقيا وأنه لم يبق سواي وصديقي سعيد على قيد الحياة، أو أنّ القيامة قد قامت.
الصباح الأول في إفريقيا. نهضت من فراشي فوجدت سعيدا قد جهّز مكانا للصلاة وجلب ماءً للوضوء. أقمنا الصلاة وصلّينا. صليّت صلاة الاستخارة لأنّ سؤالا وحيدا بقي يطنّ في رأسي: “هل أجمع أغراضي وأعود من حيث أتيت؟”
غادرنا المنزل باحثين عن فطور فقد تمكّن مني الجوع ولم يكن في البيت شيء يأكل. في الخارج، اكتشفت أنني في حيّ شعبيّ مسالكه ترابية وتغطيه الأشجار من كل جانب. كانت بعض العربات المجرورة على الأحصنة تحمل الخبز للدكاكين وعلى جانبي الطريق ترى عربات بيع اللحم المشويّ والكبدة. رائحة الشواء تملأ الأجواء. اشترينا سندويشات خبز بالجبن وقليلا من القهوة وانطلقنا باحثين عن محلاّت الصّرافة. فقد كان في جيبي عملة أجنبية ولم يكن بوسعي ليلا أن أستبدلها بالعملة المحليّة. وكنت قد نسيت سعر الصرف من هول ما رأيت من أحداث ..
أين المسير الآن؟ يجب أن أسرع في الذهاب إلى الجامعة لأتمّم إجراءات الترسيم حتى أنتزع من رأسي فكرة العودة إلى أهلي. ثمّ عليّ أن أبحث عن شقة للكراء وعن عرب. العثور على عرب في هذا البلد قد يكون هو حبل النجاة. لست عنصريا لكن غربةً في اللغة وغربةً في اللون ونظرة الناس حولي تشعرني أنني مطارد أينما التفتّ بالأخصّ في مثل هذه الأحياء الشعبيّة أين لم يتعوّد الناس على الأجانب.
في خضمّ كلّ هذا لم تفتكّ الأسئلة المحبطة تحيط بي من كل جانب. أنا الآن في نهاية المرحلة الأولى لسنوات دراسة الطبّ وعليّ أن أتدارك تلك السنوات التي أضعتها. لم يكن هناك مجال للفشل.
حتى بعد هذا التأخير يجب أن تتيقن أنّك تستطيع تجاوز كل العقبات. هذا هو التحدي الأكبر. أن تستمرّ في القتال إلى آخر رمق. لم يعد لديك خيار آخر. الجميع ينتظر منك أن تعود طبيبا.
كان هناك جملة واحدة تنزل عليّ بردا وسلاما وسط نار الأسئلة الحارقة “هذا الوقت سيمضي وهذا التعب ستخلفه راحة…” .
وصلتُ إلى الجامعة وأتممت إجراءات الترسيم واستلمت جدول المناوبة في تربّص المستشفى للأسبوع القادم. الآن فقط أستطيع أن أقول قد دقّت طبول المعركة مع العلم …

“غادرنا المنزل باحثين عن فطور فقد تمكّن مني الجوع”. عثمان سالمي، إنسان
لم يكد ينتهي اليوم حتى تذكرت أنّني لم أذق شيئا منذ الصبّاح. في الحقيقة، كنت قد فقدت شهية الأكل. ربّما هو الشعور بالغربة والتيه الّذي يشبع بطنك وقلبك وعقلك عن كلّ أكل. أنا الذي أخذت منّي النحافة كلّ مأخذ كأنني كنت ألتهم الأحداث في حياتي فتغنيني عن الطعام.
بحثنا طويلا عن نادي للإنترنت. وجدنا بعد عناء محلاّ فيه أربعة أو خمسة حواسيب قديمة. استطعت على الأقلّ تفقّد علبة الرسائل لحساب الفيسبوك. كان شعورا جميلا جدّا عندما وجدت أنّ أهلي قد أرسلوا إليّ الكثير من الرسائل، وأنّ صاحبي وخليلي صابر قد انتظر منّي جوابا يبشّره أنّي بخير.
رغم بطء الإنترنت، تمكّنت من أن أطمئن إلى أنّهم لم ينسوني. لم أكن أنتظر سوى تلك الرسائل لتشتعل فتيلة همّتي من جديد.
كان الطقس حارّا جدّا، ودرجة الرطوبة آخذة في الارتفاع. كنت أشعر بأنّني “نعوم في العرق” (أسبح في العرق) لكن الناس على ما يبدو كانوا في شُغل عن الطقس. كانت الشوارع مليئة بالمارّة والباعة.
وأنت هائم وسط الطريق ترى الخيّاط حاملا آلة الخياطة التقليدية على كتفه، والخضّار جارّا عربته أمامه، والقهوجي حاملا قدرا مملوءة بقهوة “طوبى”. طعم القهوة يشبه قهوة الشعير أوالبرهم. وترى الحلاّق ينصب كرسيّا في الهواء الطلق أمامه مرآة والناس حوله قعود، يأخذ من دمهم وشعرهم ما تيسّر. في آخر الشارع نسوة يحملن قدورا كبيرة مليئة بأرز شيبون-جان بالسمك فيما رائحة الشواء تعمر الأجواء.
هنا يراودني دائما شعور بأنني في خمسينات القرن الماضي، أدفعه كلّما اتجهتُ إلى وسط البلد وغادرت الحيّ الشعبيّ. أنا الّذي ولدت في قرية لا تختلف كثيرا عن هذه المدينة يخيفني الشعور بعودة الزمن إلى الوراء رغم أنّني، مثل الجميع، أحنّ إلى الماضي وألجأ إلى ذكرياته الفسيحة هربا من ضيق الواقع…